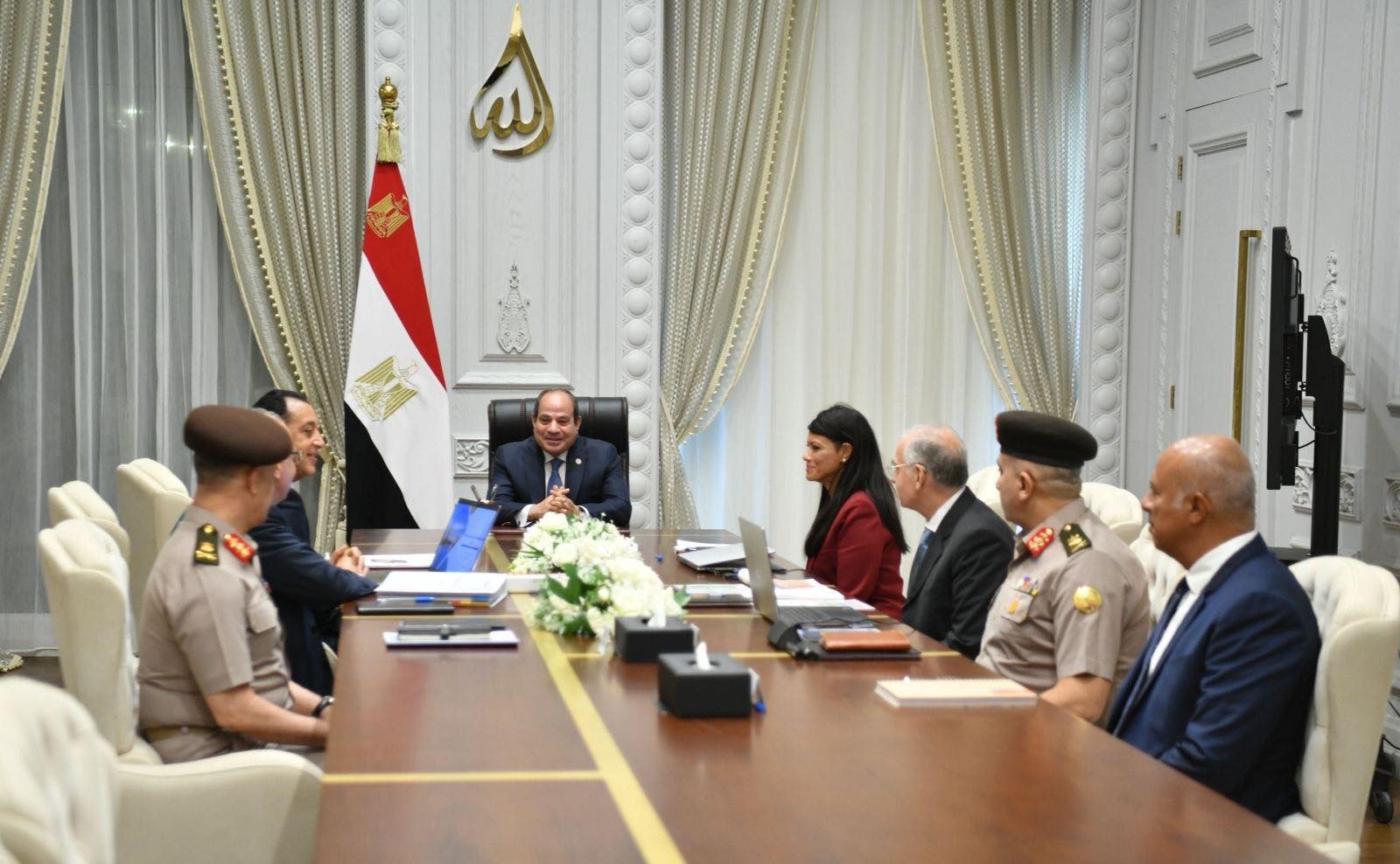«أنا مش كافر... بس الجوع كافر، المرض كافر، الفقر كافر والذل كافر» — لم تكن كلمات أغنيته مجرّد صرخة فنية، بل كانت إعلان تمرد دائم على الواقع بكل ما فيه من ظلم وتناقض. في زمن يحاول فيه الفن النأي بنفسه عن السياسة، اختار زياد الرحباني أن يكون صوتًا مختلفًا، يحمل قناعاته بجرأة، ويتعامل مع قناعات الآخرين بشك دائم.
وُلد زياد في بيت الرحابنة، لكنه لم يكن امتدادًا لتاريخهم، بل نقيضًا أحيانًا. فنانٌ عبقري، لكنه أيضًا عقلٌ مشاغب ولسانٌ حاد، لا يعرف المجاملة ولا المواربة. سلك طريقًا مليئًا بالأسئلة والانحيازات والمواقف التي أربكت جمهوره، وقسّمت محبّيه أحيانًا.
الرحباني ونصر الله.. بين الافتتان والغضب
زياد لم يكن رجلاً يمكن تصنيفه بسهولة. كان شيوعيًا حتى آخر أيامه، لكنه في الوقت ذاته أبدى إعجابًا علنيًا بشخصية دينية مثل السيد حسن نصر الله، زعيم حزب الله. هذا التناقض، كان كافيًا لإثارة غضب رفاقه في الحزب الشيوعي، خاصة أن له تاريخًا مريرًا مع حزب الله، الذي ارتبط اسمه بجرائم طالت الشيوعيين في الجنوب خلال ثمانينيات القرن الماضي.
لكن الرحباني لم يكن يخلط بين الحزب وقيادته، فبينما انتقد الحزب كتنظيم، ظل يرى في نصر الله شخصية صادقة تستحق الاحترام. وهو ما ترجم فنيًا في أوبريت قال فيه: "هذا حفيد محمد، هذا نشيد علي، هذا بشائر عيسى، هذا نصر الله". عبارة أثارت سخط اليسار، وأربكت جمهورًا كان يرى فيه رمزًا للعلمانية، فإذا به يمتدح رمزًا دينيًا.
وبرغم كل الانتقادات، لم يتراجع زياد عن موقفه، متمسكًا بخليط لا يُرضي أحدًا بالكامل: شيوعيٌ ناقد لحزبه، معجبٌ بقائد ديني، رافضٌ للاستبداد، لكنه متفهمٌ لبعضه إذا ارتبط بالمقاومة.
الثورة ليست دائمًا حرية
عُرف زياد بصوته المناصر للفقراء والعدالة الاجتماعية، لكنه صدم كثيرين حين رفض ثورات الربيع العربي، واعتبرها موجات مُبرمجة من الخارج. سخر من توقيت انطلاقها قائلاً: "فجأة صارت الشعوب بدها الديمقراطية؟!"، وهاجم الثورات في سوريا وليبيا، معتبرًا إياها محاولات لهدم الدول، لا لبنائها.
هذا الموقف لم يكن عابرًا، بل مرتبط بتجربته الشخصية مع الحرب الأهلية اللبنانية، التي رأى فيها مثالًا حيًا لانهيار الدولة وتحولها إلى ساحة صراع طائفي. وكان زياد يحذر دومًا من السقوط في فخ الفوضى، حتى لو كان الثمن هو الصبر على أنظمة استبدادية.
سوريا.. اختبار التناقض الأكبر
دعم زياد نظام بشار الأسد في وجه الثورة السورية، ما اعتُبر طعنة في قلب مبادئه. كيف لفنانٍ يساريّ أن يناصر نظامًا متهمًا بالقتل والقمع؟ لكنه عاد وانتقد النظام لاحقًا حين تحوّلت سوريا إلى بحر من الدماء، وقال: "لا أحد يدافع عن نظام الأسد، لكن الذين يريدون تغييره بهذه الطريقة كذابون… سيأتون بما هو أسوأ".
هكذا، لم ينكر زياد فداحة الاستبداد، لكنه اعتبر البديل المحتمل أكثر رعبًا، مستندًا لتجربة العراق وليبيا بعد سقوط النظام.
الرحيل من لبنان.. مضطرًا لا مختارًا
رغم الحروب والأزمات، ظل زياد في لبنان، متمسكًا بالبقاء. لكن في عام 2014، وبعد حفل أقامه على حدود الجنوب، أثار موجة من التهديدات بسبب ما اعتُبر محاولة لبث الذعر في صفوف العدو الإسرائيلي. إثر ذلك، أُبلغ بضرورة اتخاذ إجراءات أمنية صارمة، وهو ما رفضه بشدة، فاختار الخروج إلى روسيا، لا كمنفى، بل كخيار أمني، ورفض تسميته بالهجرة.
غادر أرضًا غنّى لها وعاش فيها، لا هربًا من الوطن، بل مما فُرض عليه فيه.
هل خسر الرحباني بتناقضاته؟
ربما. فالكثيرون من اليساريين رأوا في مواقفه السياسية تناقضًا كبيرًا وخيانة لمبادئه. لكن الحقيقة أن زياد لم يسع لإرضاء أحد. كان صادقًا مع نفسه إلى حد التناقض، وشجاعًا في التعبير عن آرائه، حتى لو خسر مؤيدين.
وظلت أعماله، رغم كل شيء، تجسّد صوته الحقيقي: متوتر، ساخر، مشاكس، وإنساني. وربما كان هذا التناقض هو أكثر ما جعله حقيقيًا، ومرآة لجيل بأكمله، عاش الحرب، وخبر الخذلان، وارتبك أمام كل "ثورة" بلا بوصلة واضحة.